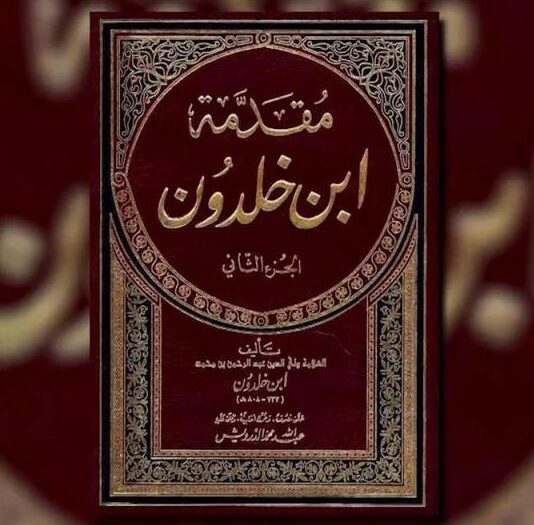بقلم: حسن إسميك – النهار العربي
الشرق اليوم – يحفل التاريخ بتجارب لم يعلم أصحابها أنها بذرة لعلوم أو فنون سيكون لها في ما بعد شأن كبير في حياة المجتمع الإنساني. فمثلاً، لم يعلم النحّاتون الإغريق والرومان أن الطرق التي اتّبعوها في صناعة تماثيلهم ستُعتمد كقواعد لفنون النحت حتى يومنا هذا، وربما لم يتوقع عبد الرحمن بن خلدون أن مقدمته ستؤسس “لعلم العمران البشري” الذي لم يكن موجوداً قبله.
انطلاقاً من إيمانه العميق بأن للدول حيوات خاصة بها، اجترح ابن خلدون في مقدمته تقسيماً جديداً لأطوار الدولة أو أجيالها، فعمرها عنده “لا يعدو في الغالب ثلاثة أجيال”، كالإنسان: الولادة والنمو ومن ثم الزوال. ومهما كانت طبيعة الدولة أو الجغرافيا التي تقوم عليها، تتميز كل واحدة من مراحل وجودها بصفات ثابتة، ففي الجيل الأول، ويمثل مرحلة التأسيس، تبرز العصبية، أي الرابط الذي يجمع أفراد الجماعة المؤسسين ويوحّد قواهم من أجل إرساء قواعد دولتهم المنشودة.
فمثلاً، على الرغم من نجاح النبي محمّد صلى الله عليه وسلم عند ولادة دولة الإسلام في إقصاء العصبيتين القبلية، بين الأوس والخزرج، والمناطقية، بين المهاجرين والأنصار، كان لا بدّ له من زرع ثالثة، هي عصبية الدّين، من أجل حشد طاقات المؤمنين لنشر الإسلام وبناء دولته.
ومع تطور الزمن وتغيّر الظروف، صارت الدول القومية التي كنا نراها في مراحل التاريخ المبكرة حتى عصر النهضة، متعددة القوميات، كما في الولايات المتحدة. وفاجأنا التاريخ بنشوء دول عدة من قومية واحدة، كما هي حال الدول العربية. واستطاعت ثورة الاتصالات متمثلة بالشبكة العنكبوتية وما أتاحته من شيوع المعرفة والمعلومات، أن توجّه ضربة قاصمة لكل أنواع العصبيات.
هكذا أصبحنا نرى أن العصبية الدينية التي تدّعي صواب أتباعها وفوزهم بنصر من عند الله على الأديان الأخرى، ومثلها العصبية القومية التي تعتبر أن أفرادها يتفوقون على غيرهم من الأقوام والأعراق، قد أصبحت جميعها موضوعاً للنقاش ولا يستطيع أحد الجزم بصحتها. لا بل إن المناهضين لهذه العصبيات، من ساسة وقادة دول ومنظّرين، باتوا أكثر من مناصريها.
ولما كانت العصبية أساس المرحلة الأولى من قيام الدول، فقد بحثت الحكومات عن لون جديد منها، وهو المواطنة. فعندما يتمتع الفرد بحقوقه المدنية الكاملة ويعيش في دعة واستقرار في وطنه الأم، سيشعر بالعصبية لدولته، وسيكون مستعداً لبذل الغالي والرخيص في سبيل تقدّمها وسلامتها. أمّا في المرحلة الثانية من دورة حياتها، فيسود الدولة الاستقرار، وتتّجه إلى التقدم الاقتصادي والعلمي، وتنتقل “من البداوة إلى الحضارة، ومن الشظف إلى التّرف” على حد تعبير ابن خلدون، كما يتمركز الحكم في شخص قائدها أو دائرته الضيّقة. وتشكّل العصبية في هذه المرحلة خطراً على الدولة، لأن كل من شارك في تأسيسها يعتبر أن له الحق بالحصول على نصيبه من غنيمة الحكم، ولا بدّ للحاكم هنا من مكافحة هذه العصبية، فيميل إلى التنظيم وإنشاء جيش ومنظومات مدفوعة بدوافع أخرى غير عاطفية، كما كانت الحال في العصبية الأولى، ولعلّها تكون اقتصادية. بالتالي ينال الجنود المرتبات والمناصب في مقابل الدفاع عن الدولة، ويكون الحاكم مضطراً لدفع عجلة الاقتصاد والتعليم من أجل بناء دولة غنية ومتحضرة قادرة على تغطية نفقات الجيش الذي يضمن بقاءها، وتأسيس الجيل الذي يضمن لها مواكبة العصر.
أما عن المرحلة الثالثة التي اعتبر أن الضعف يهيمن فيها ويمهّد إلى الانهيار، فيقول ابن خلدون إن الناس فيها “ينسون عهد البداوة والخشونة كأنها لم تكن” ويبتعدون عن العصبية وتضعف شوكة الحاكم وسلطته، وتزداد سطوة العسكريين وقادة الجيش الذين صار الاقتصاد في خدمتهم، فيتجرؤون على الحكام ولا تستطيع الدولة تغطية متطلباتهم، فينفضّون عنها وتصبح عرضة للطامعين من الخارج وللساعين إلى القبض على السلطة من الداخل، ويضطرّ الحاكم الى الاستعانة بغرباء ومرتزقة كي يعينوه على ضبط الوضع. ومن الطبيعي في هذه المرحلة انهيار الاقتصاد والتعليم ومن ثم زيادة الفقر وانتشار التخلف، فيكره الناس حاكمهم وعسكره ويتمنّون زوال سلطانهم فتحلّ نهاية الدولة التي لا بد منها.
لا شك بأن ما يميّز أفكار ابن خلدون هذه أنها تبقى حية ما بقي الوجود الإنساني. ففي دولة قديمة نسبياً مثل المملكة المتحدة التي تضمّ قوميات عدّة، يلعب الاقتصاد والتعليم دوراً كبيراً في بقائها وعبورها من عصر إلى عصر بسلاسة ومرونة، لذلك فهي تضم أرقى الجامعات والأنظمة التعليمية وأكبر الشركات الاستثمارية، بالإضافة إلى جيشها المنظم والمتطور، الذي خاض العديد من الحروب طيلة حياة هذه الدولة التي يزيد عمرها على 300 عام، أي أنه يعادل أكثر من ضعفي عمر الدول لدى ابن خلدون وهو مئة وعشرون عاماً. ولعل الإنكليز استفادوا أيّما استفادة من نظرية ابن خلدون، فاستطاعوا إبطاء دورة حياة بلادهم ولم تبلغ مرحلة الزوال.
ولا ننسى الفرق بين شكل النظام العالمي في أيام ابن خلدون عنه حالياً، إذ كان نشوء الدول وزوالها تلك الأيام أمراً مألوفاً، أمّا الآن فنحن نشهد دولاً باقية وربما إلى الأبد، في حين أن كل ما يتغيّر فيها هو أنظمة الحكم. ويعود ذلك إلى أن نظاماً عالمياً قائماً يحاول ترسيخ نفسه بشتى السبل. ففي التجربة الليبية مثلاً، وصل الضباط إلى الحكم وأرسوا قواعد دولتهم على أسس الإسلام والعروبة، وتطوّرت لتصبح دولة نفطية غنية انفرد فيها العقيد معمر القذافي بالسلطة، فانفضّت عنه الجماهير واستعان بالمرتزقة لتكوين الجيش، وسادت المحسوبيات وترسخت سلطة المتنفذين فثار الناس وانتهى النظام إلى غير رجعة، لكن الدولة بقيت قائمة.
من ناحية أخرى، قد يستغرب القارئ القول إن وصول ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة كان نتيجة طبيعية تبرهن على صحة نظرية ابن خلدون، إذ اعتمد الرئيس في حملته الانتخابية على شعار “لنجعل أميركا عظيمة من جديد” أو “أميركا أولاً”، وهما يحملان في طياتهما صورة نمطية تقليدية للعصبية التي جسّدها خطابه الشعبوي، وكان الشعب الأميركي توّاقاً إليها بعدما شعر أن بلاده لم تعد دولة حقيقية وقوية، بل باتت أشبه بتجمع عالمي يفقد هويته، وقبل كل شيء يبدّد العصبية التي تضمن بقاءه.
وفي كل الأحوال، أصبح عالم اليوم أكثر تعقيداً مما كان عليه في عصر ابن خلدون والقرون التي تلته، وربما يمكننا القول إن موازين مفهوم البدو والحضر ومقاييسه التي طالما تكلم عنها في مقدمته قد اختلفت وحلّت محلها معايير وفروقات “ما قبل الثورة التكنولوجيا وما بعدها”، فمن لا يتعامل بهذه الوسائل الحديثة يصنّف في خانة البداوة. فقد أصبحت تكنولوجيا الاتصال وشبكة الإنترنت وكل ما يتفرّع عنها من أبرز معالم الحضارة المعاصرة، التي أدت بشكل أو بآخر إلى تغيير جذري غير مسبوق في بنية الاجتماع البشري، بدءاً من الأسرة ثم الجماعة والدولة، وأخذت آثارها تظهر في ضعف الترابط الأسري، أو التواصل المباشر مع الأقارب والأصدقاء، والميل أكثر إلى الانطوائية والحد من التفاعل المباشر. ولا شك بأن الإنترنت حوّل العالم إلى قرية صغيرة تستطيع من خلالها الوصول إلى ما تريده من دون الحاجة إلى وسيط اجتماعي لتبادل المعارف. وهذا بالتحديد أخطر ما في الأمر. وأصبح العالم كله مفتوحاً من خلال التكنولوجيا على جميع العصبيات والقوميات التي بات من السهل التعرف عليها والانتماء لها أو التخلي عنها، كما سمح بانتقادها على الملأ. وهنا يراودني السؤال: هل تدعم هذه الوسائل العلاقات بين الشعوب أم العكس؟
إن الدولة عند ابن خلدون هي الامتداد المكاني والزماني لحكم العصبية التي تقوم على الدين أو القومية أو الفكر المشترك إلخ… كما أن العصبية لا تقوم هي الأخرى إلّا بالعمران الذي قصد به ابن خلدون “الاجتماع البشري”. فما هي مآلات كل هذه الأفكار الخلدونية في ظل قيام هذه القرية العالمية الصغيرة، وما هي حدود الزمان والمكان للمجتمعات والدول؟ وما شكل العصبيات التي يقوم عليها مفهوم العمران البشري والاجتماع اليوم؟
يبدو لي أنه بعد التغيرات الاجتماعية الجذرية التي سببتها التكنولوجيا ووسائل التواصل الافتراضية، أصبحت الأجوبة عن هذه الأسئلة محيّرة ولا تتسم بالدقة، وأرى أنها وضعتنا أمام فرضية أن عصبيتنا الأولى إلى زوال، وأن عالم التكنولوجيا والإنترنت يوفر لنا انتماءً لعصبية جديدة أوسع بكثير، قادرة على احتواء كل أصناف البشر بغض النظر عن أعمارهم وانتماءاتهم المناطقية أو الطائفية أو السياسية أو غيرها.
من ناحية أخرى، من الصعب الجزم ما إذا كان ابن خلدون قد أراد من خلال مقدمته توصيف حال الدول فقط من دون إرشاد الحكام والحكومات إلى الطريقة التي يحمون بها سلطانهم من الزوال. لكننا نلمس لدى الدول التي ترجمت فكر ابن خلدون ودرّسته في جامعاتها، ميلاً للاستفادة من نظريته بغرض إطالة عمرها على نحو يتناسب مع روح العصر وكأنها غير قابلة للزوال أبداً. فهل استمدت من فكر ابن خلدون الذي يبقى حياً ما بقيت الحياة الإنسانية، إكسير بقائها حين عرفت المنهج الذي تحافظ به على نفسها في مرحلة الاستقرار؟ أم أن هذه الدول ستزول يوماً ما بشكلها الحالي لتحل محلها دول أخرى، أو ربما أشكال جديدة من المؤسسات والنظم التي ستتجاوز مفهوم الدولة كله؟
 الشرق اليوم اخباري تحليلي
الشرق اليوم اخباري تحليلي