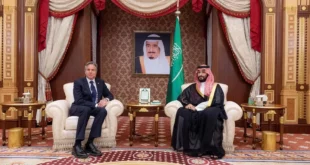بقلم: حسن إسميك- النهار العربي
الشرق اليوم- تستوقفني أثناء القراءة عبارات لافتة لبعض المفكرين والفلاسفة، أو أمثالُ بعض الشعوب، فأقف عندها متأملاً معناها وقيمتها الفكرية، بخاصة أن هذه العبارات والأمثلة شواهد على خلاصة خبرات حياتية عميقة تراكمت على مدى عقود لدى الأفراد، أو قرون لدى المجتمعات، وصارت قواعد ومبادئ يمكن أن يستفيد منها العاقل في حاضره ومستقبله. وعادة ما أختار بعض هذه الأمثال لأشاركها على صفحات وسائل التواصل مقرونة بسؤال جدلي أطرحه على المتابعين، فنتشارك جميعاً الآراء حول مضمونها ودلالاتها.
وكنت قد اقتبست منذ وقت ليس بالبعيد مثلاً يابانياً ونشرته على تويتر وفايسبوك، يقول: “يستحيل الوقوف في هذا العالم من دون الانحناء أحياناً”، ثم عقبت عليه بطرح السؤال الآتي: “برأيك ما الأمور العظيمة التي لا بأس أن ينحني الإنسان لها؟”. وكان سؤالي واضحاً وبسيطاً ومباشراً، يتصل بالطبيعة البشرية وعجزها أحياناً أمام بعض المواقف، أو قدرتها على التعامل مع الصعاب واكتشاف آليات مواجهتها، ولا أعتقد أن أحداً منا بمنجى من العقبات التي تفرضها علينا ظروف الحياة ومشكلاتها، فهذا جزء من طبيعتها كحياة، وجزء من طبيعتنا نحن كجنس بشري يشعر بالضعف تارة وبالقوة تارة أخرى. وهذا مصداق قول الحق: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 155].
كان التفاعل مع المنشور كبيراً على المنصتين، وكنت كما العادة حريصاً على الوقوف عند جميع التعليقات، ولقد شدّ انتباهي أن ما يقرب من ثلثي التعليقات قد أخرجت السؤال من مضمونه العادي وسياقه البشري الطبيعي إلى سياق الدين، فكانت أغلب الإجابات تؤكد رفض الانحناء لغير الله تعالى، وبعضها يفصّل أن هذا الانحناء لا يكون إلا في السجود والركوع. وإجابات أخرى ذكرت الانحناء للوالدين بعد الانحناء لله سبحانه، ومن الواضح أن هذا الانحناء يتصل أيضاً بسياق الدين والعبادة، وبما أمرنا الله به من بر للوالدين والإحسان إليهما والتقرب لله بصنع المعروف تجاههما.
طبعاً ما ورد في هذه الإجابات ليس خاطئاً البتة، ولكنه ليس مفيداً أيضاً لأنه لا يصيب الهدف، وتساءلت مراراً لماذا اختار أغلب المتفاعلين مع المنشور أن ينطلقوا من الدين للإجابة عن سؤال لا يحمل أي طابع ديني؟ وقد جاء طرحه في الأصل بمناسبة مثل ياباني، ومعروف أن غالبية اليابانيين لا يدينون بدين سماوي، بل ترتبط معتقداتهم الدينية بالطبيعة ويرون الخلاص بالانسجام والتوافق معها! وبدلاً من أن أطلق الحكم حول ما إذا كان موقف المشاركين هذا صحيحاً أو غير صحيح، اخترت أن أطرح في هذا المقال إشكالية العلاقة بين الدين والدنيا، والتساؤل عن ما يجعلها علاقة صحيّة وصحيحة، ولا أقصد أن يكون هذا الطرح حكماً شرعياً أو فتوى دينية، بل هو تساؤل أقرب للفلسفة منه إلى الشريعة، لذلك يبقى رأياً فكرياً سواء أصبت فيه أم أخطأت.
تجدر الإشارة أولاً إلى ما نجده بين لفظي الدين والدنيا من تقاطع لغوي وتشابه في الحروف يوحي وكأنهما من جذر مشترك، لكنهما في الحقيقة ليسا كذلك، فالدنيا مشتقة من الفعل (دنا) وجذرها (د ن و) ونقيضها الآخرة أو الحياة الثانية بعد الموت؛ أما الدين فمشتق من الفعل دان وجذره (د ي ن). وقد يرى البعض أن تشابه اللفظين مجرد مصادفة لغوية شكلية، بينما يجادل آخرون عن عبقرية خاصة في اللغة العربية تجعل اللفظين متقاربين لسبب يربط بينهما حتى لو لم يكن واضحاً. وبكل الأحوال فإن هذا التقارب اللفظي بين الكلمتين يتماثل مع الاقتران الوجودي بينهما، والذي يُعبّر عنه بتواتر ذكرهما مجتمعين معاً في سياق الكلام، الأمر الذي يولّد ما يمكن تسميته اعتقاداً نفسياً بضرورة تلازمهما. فما نوع هذا التلازم وكيف ينبغي أن يؤثر في حياتنا؟
وفي الحقيقة فإن هذه المقاربة ستقودنا الى سؤال مركزي يتبارى للإجابة عنه علماء الدين من جهة، والفلاسفة من جهة أخرى، مفاد هذا السؤال: هل الدين غاية أم وسيلة؟ ولأنه يُحكم عادة أن الغايات أهم من الوسائل – وهذا حكم متسرع وتعميم يوقع في التناقض- فسرعان ما يختار الغالبية أن الدين غاية بحد ذاته، فيكون مقدماً على الدنيا برأيهم، وهذه أيضاً مغالطة معرفية لا ينتبه لها كثيرون، إذ لا يمكن عقد المقارنة من جهة الأهمية بين مفهومين متمايزين ولكل منهما مجاله الخاص، ولا يمكن اختزال العلاقة بينهما بهذا النوع المباشر من العلاقات (أقصد أهمية أحدهما دون الآخر)، ولكي نفضّ أصل هذه العلاقة لا بد من مقاربة جوهر المفهومين، كلٍ على حدة في البداية، ثم نبحث -ما أمكن- في الرابطة الجدلية التي تربط بينهما.
ومن جهة أهمية الدين، فليس يخفى على أغلب من يتابعني من القراء، أنني عبّرت في مواقع كثيرة عن المكانة الضرورية له في حياتنا، ولدي في هذه القضية مسلمات استعرضتها في مناسبات عدة، من أهمها أنني أدافع عن حاجة الإنسان للدين أياً كان هذا الدين، إذ ثمة فرق كبير بين المؤمن – بغض النظر عمّا يؤمن به- وبين اللاديني الذي لا يعتقد بشيء بعد الموت، ويعتبر أن وجوده في الحياة مجرد صدفة طبيعية منحته فرصة العيش على هذه الأرض، وستنقضي هذه الفرصة بموته ليتحول للعدم وإلى الأبد.
ومما أدافع عنه أيضاً حقيقة العظمة والقداسة التي تختص بها الأديان السماوية: اليهودية والمسيحية والإسلام، باعتبارها تتضمن أعظم القيم التي يمكن تمثلها في حياتنا، بخاصة أن هذه الأديان تنطلق من مصدر واحد، وتمتاز جميعها بكتب سماوية ووحي إلهي أنزله الله على رسله ليبلغوا الناس أن حياتهم الدنيا عابرة، وأن ما بعد الموت هو الغاية النهائية من حياتنا، وفيه سيتحقق النعيم الذي سيناله المؤمنون الذين صدقوا في إيمانهم. ورغم اعتقادي الجازم بالمكانة العظيمة للإسلام باعتباره آخر الرسالات السماوية، فإني أيضاً أدافع عن أن الوئام بين هذه الأديان الثلاثة أولاً، ثم جميع أديان الأرض تالياً، وتكريس قيم الحوار والتسامح بينها هو أهم الفرص الواعدة لتحقيق السعادة والسلام على وجه الأرض، ومن ثم تحقيق الغاية العظيمة من وجودنا فيها.
ومع أن توضيح المكانة العظيمة للدين، والتي حاولت اختزالها في الفقرة السابقة أعلاه، يحتاج لأكثر من مقال وأكثر من كتاب، إلا أن ذلك لا يجعل منه برأيي غاية أبداً، بل وسيلة لما هو أعظم منه وأشرف، وأقصد الله سبحانه، ومعرفته والإيمان به، فهو رب هذا الوجود وخالقه، وإليه تعود غاية كل شيء. وهو سبحانه الذي كرّم الإنسان من بين مخلوقاته وخصّه بالتكليف والعبادة، وحيث أنه لا يمكن للإنسان بما لديه من قدرات محدودة أن يعرف الله حق المعرفة ويؤمن به صحيح الإيمان، فقد اقتضت إرادة الله أن تكون الأديان هي الطريق الصحيحة لهذه المعرفة وهذا الإيمان.
ولأن الله اختار الإنسان ليكون خليفة في الأرض فيعمرها بما اقتضته الإرادة الإلهية، كان شرط حسن هذه الخلافة وتمامها أن يدرك الإنسان الغاية التي وجد لأجلها، فإذا تحقق ذلك كانت له السعادة القصوى التي وإن كنّا جميعاً قد جُبلنا على السعي إليها، فإن ما يميّز السعيد عن الشقي منّا هو معرفة الطريق الصحيح لهذه السعادة أو الجهل به، فمن اعتقد بالله وقوّم سلوكه على هذا الاعتقاد فقد عرف الطريق والتزم جوهر الدين، أما من أنكر وجود الله، سواء بالقول أم بالفعل، فقد ضيّع سعادته لأنه جهل الغاية التي وُجد من أجلها.
أما الدنيا، أو الجانب الآخر في الإشكالية المطروحة، فهو الفضاء الذي فيه تتحقق خلافة الإنسان في الأرض، وقد أوجدها الله بنواميس وقوانين تناسب اختبار قدرتنا على الالتزام بأن نكون مسؤولين عن هذه الخلافة، ولا يمكن إدراك مفهوم الدنيا بالنسبة الى الإنسان إلا بتضايفه مع مفهوم الآخرة، لأن ما في الثانية من حساب وثواب وعقاب إنما يخص الإنسان وحده دوناً عن غيره من المخلوقات الحية على وجه الأرض، كما أن ما سيُحاسب عليه في الآخرة هو ما اختبره وجناه واكتسبه في الدنيا.
ولأن الدنيا دار تجربة وابتلاء، فقد حمل الإنسان مسؤوليته تجاه هذه التجربة ووعيه بها، ومُنح فرصة خوضها بغض النظر عن إيمانه أو عدم إيمانه، ليواجه فيها ما سيواجهه من مشكلات وصعوبات وعقبات، قد يقوى على بعضها ويضعف أمام بعضها الآخر، وقد ينحني (أيضاً سواء كان مؤمناً أو غير مؤمن) أمام شدائدها انحناء الضعيف العاجز المضطر، وأمام عظائمها وفضائلها انحناء الموقِر المقدِر المحترِم، وأمام مشكلاتها وأزماتها انحناء من يحسن المكر والتدبير ويبرع في معالجة الموقف كما ينبغي، مثله كمثل من ينحني أما العاصفة حتى تمر، كما تنحني الأشجار أمام الريح كي لا تُقتلع من جذورها، والانحناء هنا مفهوم ينوس بين حقلي الفيزياء والرياضيات، أما استخدمنا له فهو على سبيل المجاز الذي يوضح معنى أن تتكيف مع حالة لا يمكنك مقاومتها، أو أن تُعبّر عن عاطفة يصعب إخفاؤها، أو أن تقبل بخسارة قليلة كي لا تخسر ما هو أكبر منها.
بناء على هذا التوضيح من حيث الجوهر بين الدين والدنيا، فإن الإجابة عن سؤال مرتبط بما هو دنيوي عبر إسقاطه على ما هو ديني تعكس حالة من الجهل بكلا المفهومين، فالدين لم يوجد ليمنعنا من أن نعيش الحياة الدنيا كما هي وبما يتخللها من صعوبات ومشكلات، وهو من حيث الجوهر لا يحمينا من هذه الصعوبات والمشكلات، بل ان الأنبياء عليهم السلام عانوا ما عانوه من محن وشدائد وابتلاءات وهم يدعون لهذا الدين، فإبراهيم مرغم على دخول نار قومه، وموسى مبعد عن قومه وأهله ومُطارد من فرعون وجنده، ويوسف مسجون في غير بلاده ومنسي في سجنه، ومثلهم يونس وايوب وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وما سيرة نبينا محمد عن هذا ببعيدة، فقد اختبر الدعوة الى دين الله وواجه في سبيلها من الصعوبات ما يواجهه أي إنسان، وانحنى أمام الصعاب والشدائد، كيوم نزل عليه الوحي في الغار فرجع إلى زوجته خائفا، وانحنى حزناً وأسفا لما فقد زوجته وعمّه في العام الذي اشتهر باسم عام الحزن. ولان موقفه وانحنى حدة أمام تعنت الكفار في صلح الحديبية، فتنازل عن قليل قريب مقابل أن يكسب للإسلام الكثير ولو بعيدا. فكيف بعد كل هذا يكون من الدين أن ننكر أو نرفض الانحناء أمام رياح الحياة الدنيا العاتية وإكراهاتها الكثيرة متوهمين أن في هذا الانحناء مخالفة للإيمان!
وفي المقابل، فالغاية من الدنيا ليست الدين بحد ذاته، بل أن نحسن الخلافة في الأرض وإعمارها، ويكفي دليلاً على ذلك أن الدنيا وُجدت قبل أن يوجد الدين، ولا يمكن للوسيلة أن توجد قبل الغاية، ناهيك بأن الأرض شهدت وما زالت تشهد حتى اليوم سلالات إنسانية متعاقبة لم تعرف الدين ولا الوحي ولا الكتب السماوية.
ولكن.. هل قولنا أن الدين وسيلة هو إنقاص منه؟
يجادل الفلاسفة بأن الوسيلة لا توجد بذاتها وأنه ليس هناك ما هو وسيلة بجوهره، إنما يكون الشيء وسيلة بارتباطه بغيره، وهذا يعني أن “الوسيلة والغاية” مفهومان نسبيان، فما هو وسيلة لما هو أشرف منه يمكن أن يكون غاية لما هو أدنى منه، ويبقى المهم دائماً في ميزان الغايات والوسائل أن لا تأخذ الثانية مكان الأولى ومكانتها، فالمال مثلاً غاية التجارة أو العمل، وهما وسائل له، ولكن المال أيضاً وسيلة لسد الحاجات والحفاظ على الحياة، كما أن سدّ الحاجات وحفظ الحياة وسيلتان لغاية أكبر منهما هي تحقيق السعادة. حياتنا الدنيا إذا هي سلسلة من الوسائل والغايات التي يحكمها قانون الأسباب والنتائج، وهي غاية بذاتها في ما دون الموت، ولكنها أيضاً وسيلة لما بعده. وعلى المنوال ذاته، الدين غاية الوحي والكتب السماوية والنبوات، ووسيلة للخير الذي هو أعظم منه.
للدنيا غاية قريبة هي أن نعيش الحياة فيها كما ينبغي أن تُعاش، وهذا المقصد الحقيقي من أن نكون خلفاء نحسن الخلافة فيها؛ أما الغاية البعيدة فهي الآخرة التي لا يمكن بلوغها إلا بالمرور بالدنيا. وللدين غاية قريبة هي أن نحقق سعادتنا في الحياة الدنيا بمعرفة الخير واكتسابه، ومعرفة الشر واجتنابه؛ أما الغاية البعيدة فهي السعادة في الآخرة ونيل رضى الله وثوابه. وهذا ما اعتدت أن أدافع عنه بالمجمل، أي تكريس الدين ليكون الدين وسيلة لإحلال السلام والأمن الدوليين، ووسيلة لتطوير الحوار بين الشعوب والانفتاح على الآخر وإعلاء قيمة الاخوة الإنسانية.. فهل اعتبار الدين وسيلة ذلك كله يقلل من أهميته وقداسته؟ أعتقد أن العكس هو الصحيح.
وإذا كان صحيحاً أن الدين والدنيا غايتان للوسائل التي تسبقهما، فصحيح أيضاً أنهما وسيلتان غايتهما الإيمان بالله، والله سبحانه هو وحده الغاية النهائية التي لا تعلوها غاية، والمطلقة التي لا تجري عليها شروط وحدود ما هو نسبي.
 الشرق اليوم اخباري تحليلي
الشرق اليوم اخباري تحليلي