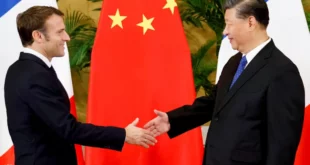بقلم: حسن إسميك – النهار العربي
الشرق اليوم – لطالما ارتبطت عندي صفة “أكاديمي” بمجموعة من السمات التي تختزلها مقاربة المواضيع الشائكة بموضوعية عالية وحياد مقبول، خاصة إذا كانت هذه المواضيع محل اختصاصه بالتحديد. لكن، كيف يصير الحال إذا كان الموضوع سياسياً وإذا كان الحديث عن البلد الذي ينتمي إليه “الأكاديمي”، إلى أي حد سيكون قادراً على تبني الموضوعية والتزام الحياد، وهل الانحياز هنا أمر خاطئ أم هو شكل مبرر من أشكال الوطنية، أم له تصنيف ثالث يجمع بين الاثنين؟
كل هذه الأسئلة جالت في رأسي بعد حديث دار بيني وبين أحد الأصدقاء القدامى، وهو أكاديمي روسي، وأستاذ محاضر في تاريخ الأفكار السياسية، موضوع الحديث طبعاً هو الحرب الدائرة منذ ما يزيد عن شهرين، والتي شنتها بلاده على جارتها أوكرانيا… لم يكن هذا الحديث هو الأول بيننا حول هذا الموضوع، فمنذ أن بدأ صوت طبول الحرب يعلو مع ارتفاع التصعيد والتصعيد المضاد بين روسيا والغرب منذ مطلع العام أو قبله بقليل حتى، حاولت أن أبقى على تواصل معه، علَّه يرسم لي الصورة من المنظور الروسي لكن بموضوعية اعتدتها منه في حواراتنا السابقة. وبالفعل، لم يخب ظني في ذلك الوقت، فقد تعامل صديقي حينها مع الوقائع والمجريات على الأرض بعلمية، وبمنطقية الأكاديمي التي قد توقعه في كثير من الأحيان في مطب الفجوة ما بين النظرية والتطبيق في السياسة.
لم يستشرف صديقي وقوع الحرب، ولم يتوقع أن تشن بلاده أية عملية عسكرية مباشرة على أوكرانيا، ناهيك عن حرب ضخمة وشاملة وطويلة، فهذا القرار مناف للمنطق برأيه –ومعه حق، وأذكر أنه قال لي: «لمَ الحرب وروسيا قادرة على الاستمرار بالضغط من خلال التخويف واستعراض القوة وإبداء مجرد الجاهزية لاستخدامها، للحصول على ما تريده من كييف، ومن الغرب بالعموم، سواء أكان ذلك متعلقاً بجمهوريتي إقليم دونباس، أو بدفع الحكومة الأوكرانية نحو طاولة مفاوضات حول “حق روسيا في القرم”، أو حول تحوِّل أوكرانيا إلى دولة محايدة وضمان عدم انضوائها، اليوم أو مستقبلاً، في حلف شمال الأطلسي».
لقد كنت متفقاً معه إلى حدٍّ كبير في ذلك الوقت، رغم أننا كنا منطلقين من خلفيتين مختلفتين، وأخبرته عندها بذلك، وقلت له: «لا أظنك مخطئاً لكل الأسباب التي قلتها، ولأن “المصيدة” التي ينصبها الغرب لبوتين واضحة وغير خافية على أحد وبالتالي لا أظن أن ثقته بنفسه مهما ارتفعت ستصل به حد رمي نفسه –وبلاده– في الفخ الذي يعده الغرب منذ سنوات، ربما منذ عام 2008 وما حدث في جورجيا فيما يختص بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية». شعرت حينها أن فكرتي هذه لم تعجبه كثيراً وأهملها ولم يتجاوب معها كما اعتاد مع ما يُطرح أحياناً من أفكار في حواراتنا، لكنني لم أتوقف عند ذلك وتابعت بالقول: «أضف إلى ذلك أن دخول روسيا في حرب مع أوكرانيا، يعني أنها تخاطر باندلاع حرب مفتوحة مع الناتو، وقد تصل إلى مستوى حرب عالمية ثالثة في قلب أوروبا، هل هم مستعدون هناك في موسكو لهكذا مجازفة؟». هنا ضحك صديقي واتهمني بشيء من المبالغة، فبرأيه –وأنا أعرف مدى اعتداده بالقوة العسكرية الروسية– أن الغربيين أنفسهم لن يخاطروا بحصول هذا السيناريو، وأن من المستحيل أن تتطور الأمور إلى هذا الحد، وقال لي بالحرف: «لن يكون لديهم [ويقصد الغرب] ما يكفي من الوقت، فمنظومة روسيا الصاروخية لا مثيل لها في العالم كله، وإذا أراد الجيش الروسي فهو قادر على احتلال أوكرانيا بأكملها خلال أربعة أيام».
انتهى حوارنا الأول عند هذا الحد، فرغم الاختلاف الشديد بيننا في الآراء، وفي كيفية قراءة الواقع على الأرض ومجرياتها ومساراتها وسيرورتها، إلا أننا كنا متفقين إلى حد ما على النتيجة، أو ربما كنا نحن الاثنين نتمنى ألا تندلع الحرب فكلانا من ألد أعدائها ورافضيها ومناهضيها… لكن للأسف حصل ما لم يكن أيٌّ منا يتمناه، وبالفعل شنت موسكو “عملية عسكرية خاصة” على أوكرانيا، ما زالت مستمرة بعد مرور أكثر من شهرين على بدايتها، تحصد الأرواح وتدمر المدن وتحمل الخراب، ليس على أوكرانيا فقط بل على الكثير من دول العالم وفي مقدمتهم روسيا نفسها.
منذ بضعة أيام كنتُ أفكر بكتابة مقال افترضت أن يكون عنوانه “الحجر الأوكراني أصاب مئة عصفور روسي!” لأتحدث فيه عن الخسائر التي تكبدتها روسيا في حرب هي بدأتها، سواء أكانت خسائر عسكرية أو اقتصادية ناجمة عن الحصار والعقوبات ومقاطعة المنتجات الروسية، أو حتى تلك الخسائر شبه المعنوية المرتبطة بعدم قدرة موسكو على تحقيق أهدافها من الحرب حتى بعد مضي أكثر من شهرين على اندلاعها، وبانكشاف ضعف القدرات العسكرية الروسية على الجميع، حيث استطاع الناتو بالتأكيد الاطلاع على كل ما في الترسانة الروسية من أسلحة، خاصة الصاروخية، وباتت دوله اليوم تستطيع بسهولة تقدير قوة الجيش الروسي الذي كان يعدُّ ثاني أقوى الجيوش في العالم، ناهيك عن “النبذ” الذي تعاني منه روسيا اليوم من قبل الكثير من دول العالم التي ترى أنها “عدوانية” تجاه الجميع دون استثناء.
لا أدري صراحة لمَ شعرت بالرغبة في تداول هذه الأفكار ومناقشتها مع صديقي الروسي بشكل شخصي وقبل أن أشرع في الكتابة، فقد انتابني فضول شديد لأعرف رأيه في ما يجري اليوم من أحداث، وفي ما وصلت إليه الحرب من نتائج، وفي “المصيدة” التي وقعت فيها القيادة الروسية، والتي عدَّها هو شيئاً من “المبالغة” في حديثنا السابق.. وهذا ما فعلته.
بعد السلام والترحيب والاطمئنان عن الأحوال، عرضت عليه ما أفكر به بإيجاز وتركيز، وسألته عن رأيه “العلمي والأكاديمي” بالمقابل، فأجابني باتهام صاغه كاستغراب، حيث قال: «أعجبُ لانحيازك الشديد نحو الغرب، ألا تعلم أنهم دائماً يحيكون المؤامرات وأن ما يرفعونه من شعارات حول الديموقراطية وقيم الحرية والإنسانية غطاء على أعمالهم، فهذه الدول التي تسمي نفسها بـ “العالم الحر” لا تفكر إلا في مصالحها، وهي لا تتردد في القتل والتدمير وتجاوز القوانين الدولية لتحقيق تلك المصالح». وتابع فوراً وقبل أن يعطيني أي مجال للرد: «هذا مثير للاستغراب حقاً، خاصة لكونك عربياً، وأنتم من أكثر الشعوب التي عانت من الغرب وأطماعه واستغلاله، وعانت بشكل مباشر –قديماً وحديثاً– العنجهية الغربية، والنزعة العرقية الفوقية عند الغرب تجاه الشرق ولاسيما العربي، ألم يكن ذلك واضحاً في هجرة السوريين وكيفية التعامل معهم على الحدود الأوروبية، بكل بشاعة وعنف.. ألم تجد فرقاً بين تعامل الأوروبيين مع اللاجئين الأوكرانيين بمقابل اللاجئين العرب أو السمر بالعموم؟!».
لقد أخذني كلامه على حين غرة، فلم أتوقع رداً كهذا على الإطلاق، ولم أتوقع أن ينقل الحديث من الكلام عما يجري في أوكرانيا إلى موقفي الشخصي من الغرب، أو رأيي في تعاملهم مع العرب. فأجبته متوخياً أكبر قدر ممكن من الهدوء واللطف–خاصة وأني استشعرت حدة وتوتراً في نبرته وطريقة كلامه لم أعتدها منه سابقاً: «ومن قال إني لا أرى أن الغرب يحتل مرتبة الصدارة في المخططات السياسية المحكمة، ألم أقل في حديثنا الماضي أنهم يعدون لهذه المصيدة منذ نحو عقد ونيَّف، وأنهم يدرسون كل تصرفات الرئيس الروسي على امتداد سنوات لاختيار الفتيل المناسب لإشعال الحرب وتحقيق الفوائد من ورائها، وأنت تعلم كم أكره الحرب، وكم أحارب لأنني أدعو للسلام في كل مكان وزمان»، وعندما هم بالكلام لم أسمح له أنا هذه المرة، وتابعت بالقول وبلهجة فيها من الجد ما فيها من المزاح: «ثم ماذا فعلت بصديقي “أستاذ السياسة”، لو سمعك تتحدث عن “الأخلاق” في العلاقات الدولية، وعن اللاجئين العرب وغيرهم، لأصيب بالدهشة إلى حد الصدمة مما تقول! أنت تعلم أن معظم الحوادث فردية ولا تعبر عن سياسات الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين، وغيرهم من العرب قديماً وراهناً، وقدمت لهم الحياة الكريمة والأمل بالمستقبل، ثم أني لا أستغرب أن يتم التعامل مع الأوكرانيين بطريقة مختلفة، فالغربيون يرونهم على أنهم خط الدفاع الأول ضد روسيا “المعتدية”، وأنهم يقاتلون ويموتون بدلاً عن شعوب أوروبا كلها، ودون أن أنكر وجود مستويات من العنصرية، وهي داء ما زلنا نحن وأنتم والعالم كله يعاني منه وباعتراف الجميع».
هنا هدأ محاوري قليلاً وقال: «أتريدني أن أسمعك تقول إن بلادي وقعت في فخ واضح، واتخذت خطوات غير محسوبة العواقب، وألا أغضب أبداً». فذكرته فوراً بحديث سابق لنا وقلت: «ألست أنت من قال، وفي معرض حديث عن النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، إن القوى العظمى تتصرف أحياناً بطرق رهيبة وحمقاء عندما تعتقد أن مصالحها الأمنية الأساسية معرضة للخطر، ألم يكن هذا كلامك عن الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ما وجه الاختلاف عن الغزو الروسي لأوكرانيا؟.. ثم إنك تعلم –وربما أكثر من الجميع– حجم الأدبيات السياسية التي تتحدث عن سوء الفهم أو التقدير ومدى تأثير ذلك على العلاقات بين الدول. ولا يمكن لأحد أن ينفي أن بوتين أخطأ التقدير من نواح مختلفة، فلا أظنه توقع أن يقف الغرب متماسكاً إلى جانب أوكرانيا متحملاً أزمة الوقود الخانقة الناتجة عن مقاطعة النفط الروسي، ولا أن يقدموا لها هذا الكم الهائل من الدعم العسكري والمادي والإنساني، بالمقابل ربما يكون قد بالغ بتقدير قدرة جيشه على تحقيق نصر سريع ومنخفض التكلفة، أنت ذاتك قلت إن الجيش الروسي قادر على احتلال أوكرانيا خلال أيام».
أظن أن الجملة الأخيرة أشعلت ما خمد من موضوعية لدى “صديقي الأكاديمي” بفعل حبه الشديد والتعصب للوطن، هذا النوع الوحيد من التعصب الذي ما زلت لا أعرف إذا كانت محاربته واجبة أم لا… وبالطبع استمر حديثنا مدة لا بأس بها فاختلفنا حيناً واتفقنا آخر، وبقيت أشعر أن في كلامه مستوى ما من التحيز لم يستطع التخلص منه تماماً، ولا ألومه فما يحدث اليوم في بلاده يشكل تهديداً حقيقياً لمكانتها العالمية وعلى كافة المستويات: سياسيا واقتصادياً وعسكرياً وبالتالي لمجتمعها ككل، ولا يبدو أن هذا التهديد في طريقه إلى الزوال قريباً، بل على العكس فالكثير من دول الجوار الروسي التي كانت محايدة تفكر الآن في الانضمام إلى الناتو- مثل السويد وفنلندا حالياً والحبل على الجرار-، والحصار القوي يكاد أن يدمر روسيا. لكنه كان مدركاً تماماً لتحيزه هذا، وترجم لي مثلاً أو حكمة بالروسية تقول في ما معناه: “نظل باردين (غير مكترثين) إلى أن يتعلق الأمر بالوطن”، وانتهى هنا حديثنا لكنني بقيت أفكر بأن هذا القول غير مناسب بما يكفي، فالدفاع على الوطن ليس الحال هنا بل العكس، وربما لو كان صديقي يجيد العربية بما يكفي لرددت له قول الشاعر العربي دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ:
ومَا أنَا إلا من غَزِيَّةَ إنْ غوَتْ غوَيْتُ وإنْ تَرشُدْ غزَّيَةُ أَرْشُدِ
ولكي أطيب خاطر صديقي بعدما قسوت ونقدت، أكدت له أن كلانا يلتزم في ما يغني الحوار، وأن غايتنا واحدة هي الخروج من الدائرة التي نقع فيها نحن العرب، وأنتم الروس أيضاً، فنعيد نفس الأخطاء ولا نتعلم درس التاريخ. وتساءلت أمامه لماذا ما زال قرار الحرب والسلم في مجتمعاتنا حكراً على الفرد الواحد وبعيداً عن التداول المؤسساتي الديموقراطي والحر؟ لماذا ما زالت أيدينا متشبثة بأسباب مصائبنا وقد تغير العالم من حولنا وتبدلت شروطه وقوانينه؟ خاصة بعدما أصبحت الحروب العسكرية من الماضي، كما وأصبحت فكرة احتلال الدول أمراً غير منطقي، سواء في النظرية أو الممارسة! أفلم يحن بعد لمجتمعاتنا أن تتنعم بالحريات وتعدد الآراء، وأن تخطو خطواتها الأولى نحو التطور والنمو ومنافسة الغرب وبلوغ ما بلغه في هذا المجال؟ تخيل يا صديقي لو أن روسيا بكل ما تملكه من إمكانيات جغرافية وطبيعية وعسكرية سمحت بالحرية والانفتاح والتحول الديموقراطي، أفلن تصبح حينها الدولة العظمى التي تريدونها؟ وافقني صديقي في كل ما قلت، وعلق الأمر كله على الخلاص من الخوف الذي يحكمنا بسيف من الماضي ما زال مسلطاً فوق الرؤوس.
أخيراً… استذكرت عندما كنت أسافر إلى روسيا، كيف كنت ألاحظ وجهيها المتناقضين، وجه ظاهري تبدو عليه روسيا في كل الملامح الشكلية كدولة حديثة، سواء في نمط العيش والأكل والأسواق والسيارات وطرق الترفيه، ووجه آخر تحته يناقضه تماماً، حيث ما تزال تُدار مؤسسات الدولة وقوانينها بالعقلية والنمط ذاته الذي كان يقوم عليه الاتحاد السوفياتي، سواء من جهة التشكيك بالآخر والخوف منه، واعتباره دائماً عدواً متهماً بالسوء والتخوين، أو من جهة القمع وكتم الحرية وإجهاض كل ما هو مؤسساتي وحر وديموقراطي.
واستذكرت أيضاً أنني كلما زرت روسيا، كيف كنت أشعر بعظمتها وأهمية ما منحها الله من ثروات وخيرات طبيعية لا محدودة، فهي الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها عالمياً، فهي من أكبر دول العالم براً وبحراً، وفيها شعب قوي صبور ومكافح، وكنت دائماً أتخيل اليوم الذي ستتحول فيه إلى الديموقراطية ونظام المؤسسات، وتنزع عنها الاستبداد الفردي المجحف، وتُفتح فيها أبواب الحريات على مصراعيها، ويتحرر شعبها الطيب والودود من قسوة الخوف والقمع. كيف ستصبح روسيا حين يتحقق ذلك؟ لا شك حينها أن جامعاتها ستكون منارة لحرية الفكر، ومنافساً قوياً لمثيلاتها الأوروبية والأميركية، حينها ستكون هذه الدولة قادرة على فرض دورها العالمي حتى على الغرب ذاته، وعلى فرض احترامها بالترهيب أو الترغيب على حد سواء، لأنها ستكون الأقوى اقتصاديا وسياسياً.. وبلا منازع.
 الشرق اليوم اخباري تحليلي
الشرق اليوم اخباري تحليلي