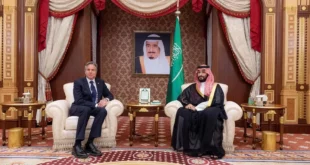بقلم: رياض قهوجي – النهار العربي
الشرق اليوم – يرفض العديد من الناس فكرة أن دولة عظمى مثل أميركا يمكن أن يخطئ قادتها ومسؤولوها في تقديراتهم وقراراتهم، وبالتالي يرون في كل خطوة قامت وتقوم بها هذه الدولة العظمى جزءاً من مخطط أو مؤامرة تحوكها مجموعة من العباقرة معصومين عن الخطأ، وقادرين على رسم مسار سياسات متعددة على مدار عقود من الزمن. وتمتاز منطقة الشرق الأوسط بوجود العديد من هؤلاء المؤمنين بـ”نظرية المؤامرة” الأميركية التي لا تنتهي فصولها، والذين يعتبرون أنه حتى لو تعرضت مصالح أميركا لأي ضربات وبدا أن سياسات واشنطن تعرضت لانتكاسة، فإن ذلك جزء من مخطط يخدم أهداف أميركا الكبرى التي نحن كعرب أو مواطنين من دول العالم الثالث عاجزون عن فهمها وإدراكها.
باختصار، بالنسبة إلى جماعة “نظرية المؤامرة،” أميركا لا تخطئ. ولقد ظهر هذا جلياً خلال العقدين الأخيرين من خلال العديد من التقارير والتحليلات، وآخرها الانسحاب الأميركي من أفغانستان، والتي ترى في ما يجري نتيجة لخطط وضعها مسؤولون أميركيون منذ زمن. هناك من لا يزال يتحدث عن مخطط هنري كيسنجر الذي خرج من السلطة قبل نحو خمسين عاماً، وآخرون يتحدثون عن نظرية “الفوضى المنظمة” للمحافظين الجدد.
تمكّنت الولايات المتحدة في أقل من قرن من التحول من دولة خرجت حديثاً من حرب أهلية وتعيش في عزلة على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، إلى القوة العظمى المهيمنة عالمياً والأكثر تقدماً تكنولوجياً. فهي من مكّن دول غرب أوروبا من الانتصار في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وهي من خرجت منتصرة من الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي ووضعت أسس منظومة الحوكمة العالمية التي بُني النظام العالمي الحالي على أساسها. لعل هذا الصعود السريع والأسطوري لأميركا هو أهم أسباب اقتناع العديد من الناس بأن صنّاع القرار في أميركا يعرفون كل شيء ولا يخطئون.
ولأن أميركا كانت طرفاً مؤثراً في تطور الحوادث في الشرق الأوسط، بخاصة في ما يخص الصراع العربي – الإسرائيلي، ومن ثم حرب تحرير الكويت ولاحقاً اجتياح العراق، فهي رسخت لنفسها صورة في أذهان العديد من الناس بأنها دولة لا تُهزم، ودائماً تحقق أهدافها من دون أي أخطاء. وهناك حتى من يتعاطون الشأن العام ويحتلون مناصب حكومية مهمة في المنطقة ممن يؤمنون بنظرية المؤامرة الأميركية ويتصرفون على أساسها. فما هو واقع الحال؟
الدول عبر التاريخ تنجح وتصل إلى درجة العظمة بحسب نوعية قادتها وامتلاكها مصادر القوة الأساسية: القدرات الاقتصادية، التكنولوجيا العسكرية والموارد البشرية. ولقد ظهرت امبراطوريات عديدة عبر الأزمنة شهدت عبر مراحل وجودها فترات من تعاظم نفوذها وتراجعه قبل أن تنهار في نهاية الأمر، فإما تختفي كلياً أو تتقلص إلى دولة عادية أو قوة متوسطة، كما هي الحال بالنسبة إلى الإمبراطوريتين اليابانية والبريطانية اللتين تقلص حجمهما خلال القرن الماضي تقلصاً كبيراً إلى ما هما عليه اليوم. وهذا ينطبق على أميركا التي لا تزال اليوم تتمتع بنفوذ كبير عالمياً، لكنها تواجه تحديات داخلية وخارجية تؤثر في أدائها وقراراتها وعلاقاتها مع حلفائها. أهم ما يؤثر في قرارات السياسة الخارجية الأميركية، هو شخصية المسؤولين والوضع الداخلي ومجموعات الضغط التابعة للشركات العملاقة التي تملك مصانع السلاح والتكنولوجيا والمصارف ومصافي النفط وناقلاته، ومنشآت الطاقة وإدارة المناجم حول العالم.
نوعية القيادات السياسية في أميركا تغيّرت كثيراً منذ نشأتها حتى يومنا هذا. فأحد مؤسسي الجمهورية ورئيس الولايات المتحدة الثالث توماس جيفرسون كان عالماً وفيلسوفاً ومهندساً ودبلوماسياً مميزاً، في حين أن رئيس أميركا الخامس والأربعين كان رجل أعمال ملاحقاً بدعاوى قضائية بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي والتحرش الجنسي اسمه دونالد ترامب. مستوى الأخلاقيات في السياسة تغيّر، ومعايير انتخاب الرؤساء تراجعت كثيراً. ولقد أثرت الثورة في الإعلام والاتصالات تأثيراً كبيراً في عالم السياسة في الأنظمة الليبرالية الديموقراطية، حيث بات الشخص الذي يستطيع أن يستقطب اهتمام الإعلام واستخدام شعارات شعبوية رنانة يتمكن من حشد ما يكفي من الأصوات للوصول إلى السلطة، بغضّ النظر عن أجندته السياسية أو كفاءته المهنية. وهذا أحدث خللاً كبيراً في دوائر صنع القرار، إذ إن نوعية المسؤولين تتدنى، ما أثّر في سياسات الحكومة الأميركية عامّة والخارجية منها خاصّة.
أما داخلياً، فإن أميركا تشهد انقساماً أفقياً حاداً بين اليمين المحافظ واليسار الليبرالي، ومرد ذلك إلى تراكمات لسياسات تبنتها الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ انتهاء الحرب العالمية وخلال الحرب الباردة إلى يومنا هذا. وأدى تصاعد دور الشركات العملاقة والثورة التكنولوجية إلى خسارة العديد من المزارعين والعمال الأميركيين مزارعهم ووظائهم في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ما أوجد نقمة لدى شريحة مهمة من سكان الوسط والجنوب الأميركيين على صناع القرار في واشنطن. كما أن سياسة استقبال المهاجرين من جنوب أميركا وأفريقيا والشرق الأوسط، ممن هم من البشرة السمراء ومن غير المسيحيين الإنجيليين، زاد من منسوب الشعور بالتهديد لدى العديد من الأميركيين البيض الإنجيليين الذين يشكلون الشريحة الأكبر من السكان. ولقد أدى هذا لتنامي النزعات العنصرية واتساع عدد المؤيدين لليمين المتشدد الذي يعارض استقبال المهاجرين غير البيض والمسلمين وتجنيسهم.
وكان وصول أول رئيس من أصول أفريقية إلى الحكم، باراك أوباما، القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى جزء كبير من الأميركيين البيض. ولقد أحسن ترامب استغلال ذلك في حملته الانتخابية، ما أوصله إلى البيت الأبيض. هذا الانقسام ما زال موجوداً، وأظهرته الانتخابات الأخيرة، ويبيّنه الالتفاف الكبير للجمهوريين في الكونغرس حول ترامب. هذا الانقسام الداخلي يؤثر كثيراً في السياسة الخارجية لواشنطن، الأمر الذي على المجتمع الدولي عامّة وحلفاء أميركا خاصّة، أن يتعايشوا معه لفترة من الزمن قد تكون طويلة، وسيترك تداعيات كبيرة وغير معروفة حتى الآن.
تأثير مجموعات الضغط أو ما يسمى بلوبيات الشركات الكبيرة، بخاصة العسكرية منها، في السياسة الخارجية الأميركية، هو أمر أكّدته العديد من الوقائع والدراسات في الولايات المتحدة وخارجها. حتى أن الرئيس الرابع والثلاثين لأميركا الجنرال دوايت أيزنهاور حذر في خطابه الوداعي للأمة عام 1961 من تداعيات “تأثير المجمع الصناعي العسكري” في قرارات الحكومة. وما التقارير التي تظهر بين الحين والآخر (والتي سيظهر المزيد منها مستقبلاً) حول مليارات الدولارات التي أُنفقت في حربي العراق وأفغانستان وحروب أخرى في الشرق الأوسط، سوى دليل على كم استفادت هذه الشركات الدفاعية من سياسات أميركا الخارجية خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
إذا ما تم جمع التغيير في نوعية القيادات مع الانقسامات الداخلية وتعاظم نفوذ المجمع الصناعي العسكري، تتكوّن صورة أوضح عن العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية الأميركية، وتُعرف أسباب التناقضات الكبيرة فيها وعدم التزامها استراتيجية متينة قابلة للاستمرار، ومبنيّة على عقيدة راسخة كما كانت عليه في النصف الأول من القرن الماضي. وكونها دولة عظمى غنية بموارد اقتصادية وعسكرية، تستطيع أميركا تحمّل أعباء السياسات الخارجية الفاشلة والانسحاب وترك حلفائها لمواجهة مصيرهم المشؤوم، كما كانت الحال في أفغانستان. فحقبة التخطيط الاستراتيجي الأميركي الطويل الأمد انتهت في أواخر خمسينات القرن الماضي، واليوم عمر أي استراتيجية للإدارة الأميركية هو غالباً من عمر فترة ساكن البيت الأبيض، أي من أربع إلى ثماني سنوات. الخطر على أميركا هو أن تفقد ثقة غالبية حلفائها، وتبقى في الساحة الدولية وحيدة لمواجهة القوى العظمى الصاعدة، وتحديداً الصين.
 الشرق اليوم اخباري تحليلي
الشرق اليوم اخباري تحليلي